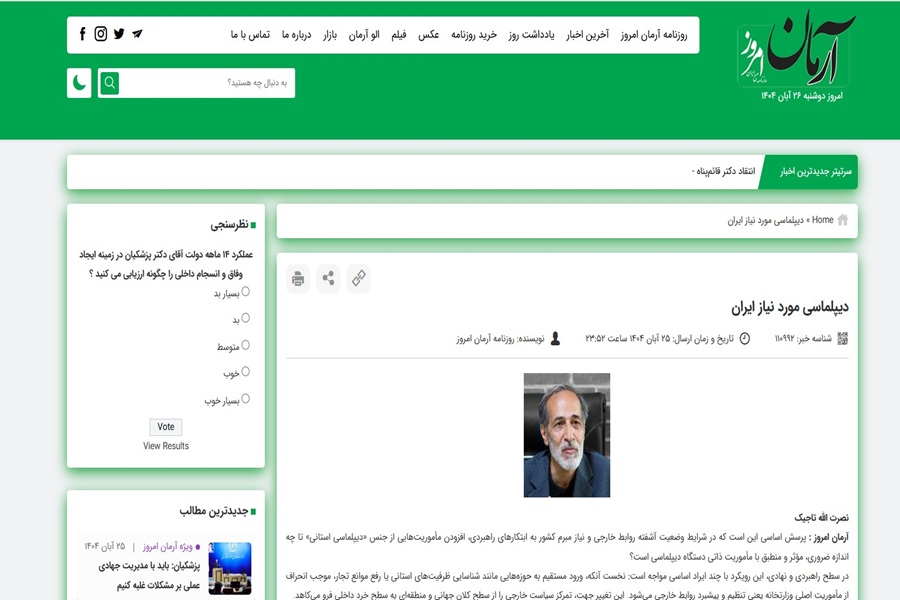السؤال الجوهري هو: في ظلّ الاضطراب الذي يكتنف العلاقات الخارجية، والحاجة الماسّة إلى ابتكارات إستراتيجية جديدة، إلى أيّ حدّ تُعدّ إضافة مهامّ من قبيل «الدبلوماسية الإقليمية» أمراً ضرورياً ومجدياً وموافقاً للمهامّ الجوهرية للجهاز الدبلوماسي؟
على المستوى الإستراتيجي والمؤسسي، يواجه هذا الأمر عدة انتقادات أساسية، هي:
أولاً: إنّ الدخول المباشر في مجالات مثل تحديد القدرات الإقليمية للمحافظات، أو إزالة العقبات أمام التجار، يفضي إلى الانحراف عن المهمة الأصلية للوزارة، وهي تنظيم العلاقات الخارجية وتطورها.
هذا التحوّل في الاتجاه يهبط بتركيز السياسة الخارجية من المستوى الكلّي العالمي والإقليمي إلى مستوى جزئي داخلي محدود.
ثانياً: إنّ هذا المشروع، أكثر من كونه مبادرة استباقية، فهو ردّ فعل على مأزق السياسة الخارجية على المستوى الكلّي.
فعندما تكون علاقات طهران مع الغرب في حالة من الجمود، ولا تمتلك السياسة الخارجية إزاء روسيا والصين برنامجاً واضحاً وعملياً على المستوى الإستراتيجي، يسعى الجهاز الدبلوماسي إلى إظهار نوع من الحيوية الشكلية عبر عقد مؤتمرات إقليمية.
غير أنّ هذا العرض المتمثّل في «النشاط الظاهري» لا يمكن أن يكون بديلاً عن غياب المبادرات الحقيقية في مجالات تخفيف العقوبات، وإدارة التوترات الإقليمية، أو إعادة تعريف موقع إيران في النظام العالمي المتحوّل.
ثالثاً: إنّ تنفيذ «الدبلوماسية الإقليمية» في إطار بنية الحكم المعقّدة والمتعارضة أحياناً في إيران يزيد من مخاطر عدم الانسجام المؤسسي.
فالتداخل بين أدوار المحافظين وغرف التجارة ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة ووزارة الخارجية، قد يؤدي إلى تعدّد مراكز اتخاذ القرار وتفاقم الازدواجية في العمل.
بينما تكمن المشكلة الأساسية لدى الفاعلين الاقتصاديين لا في نقص المؤتمرات ولا في ضعف الدبلوماسية الإقليمية، بل في غياب المبادرة في الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية، وانعدام البنى التحتية المصرفية والتأمينية والجمركية والقانونية اللازمة للتجارة الخارجية.
وما دام النظام المالي للبلاد مفصولاً عن النظام المالي العالمي، وما دامت الاتفاقات النقدية والتأمينات الخاصة بالصادرات غير مفعّلة، فلن يكون لأيّ اجتماع إقليمي القدرة على إحداث تغيير في العلاقات الاقتصادية.
رابعاً: في وقت يجب أن يكون فيه تركيز السياسة الخارجية لإيران منصبّاً على حلّ التوترات الإقليمية، والاستفادة الذكية من العلاقات مع روسيا والصين، وإحياء مسار الحوار مع الغرب، فإنّ توسيع مشاريع من هذا النوع أقرب إلى تبديل الأولويات منه إلى إصلاح السياسة.
فمثل هذه البرامج قد تسهم ــ في أفضل الأحوال ــ في إنعاش محدود للتجارة الحدودية، لكنها على المستوى الكلّي لن يكون لها أثر يُذكر في مكانة إيران الدولية.
وفي الختام، يمكن القول إنّ «الدبلوماسية الإقليمية» ــ وإن بدت ظاهرياً سعياً لربط السياسة الخارجية بالاقتصاد الداخلي ــ هي في الواقع مؤشر على ردّ فعل انفعالي من قبل الجهاز الدبلوماسي أمام المآزق البنيوية.
فهذا المشروع يحمل طابعاً رمزياً وإعلامياً أكثر مما يمتلك من وظيفة عملية في تحقيق الانفراج الاقتصادي أو الارتقاء بالموقع الدولي لإيران.
****
رؤية تحليلية: (المترجمة)
في هذا المقال، يقدّم نصرة الله طاجيك قراءة نقدية عميقة لظاهرة «الدبلوماسية الإقليمية» التي تروّج لها وزارة الخارجية الإيرانية في السنوات الأخيرة، ويضعها في سياق الأزمات البنيوية التي تعاني منها السياسة الخارجية للبلاد.
ويمكن تلخيص التحليل في النقاط التالية:
1ــ الدبلوماسية الإقليمية كبديل شكلي عن المبادرات الجوهرية
يرى الكاتب أنّ هذا التوجّه ليس ثمرة تخطيط إستراتيجي، بل محاولة لإظهار نشاط خارجي في وقت تعاني فيه السياسة الخارجية من جمود وانسداد في المسارات الأساسية، سواء في العلاقة مع الغرب أو في استثمار العلاقات مع روسيا والصين.
هذا الاستنتاج منطقي، إذ إنّ أي ابتكار دبلوماسي حقيقي ينبغي أن ينبع من رؤية إستراتيجية شاملة، لا من حاجة لتوليد «ضجيج حركي» يغطّي على غياب المبادرات الكبرى.
2ــ انحراف عن وظائف وزارة الخارجية
يشير المقال إلى أنّ انخراط وزارة الخارجية في ملفات محلية مثل إزالة معوّقات التجار أو تفعيل قدرات المحافظات يبدّد تركيزها على الملفات الدولية التي تُعدّ جوهر عملها.
وهذا نقد مهم، لأنّ الدبلوماسية إذا تحوّلت إلى جهاز خدماتي محلي، فقدت قدرتها على صياغة السياسات العليا والتفاوض الدولي.
3ــ التشتت المؤسسي وتضارب الصلاحيات
ينبهنا الكاتب إلى مشكلة جوهرية في بنية الحكم الإيرانية ألا وهي تعدّد مراكز القرار وتداخل المهام. ويرى أن الدبلوماسية الإقليمية، بدلاً من حلّ الأزمة، قد تضاعف من هذه الفوضى بتوسيع مساحات التدخل المؤسسي دون إصلاح جذري للمنظومة.
وهذا نقد واقعي، لأنّ أي مبادرة اقتصادية خارجية تحتاج إلى جهاز منسجم، وبنى مصرفية وجمركية وقانونية فعّالة، لا إلى مزيد من المؤتمرات.
4ــ غياب الأساس الاقتصادي والمالي
يقدّم الكاتب إحدى أقوى حججه هنا: ما دامت إيران مفصولة عن النظام المالي العالمي نتيجة العقوبات، وما دامت لا توجد آليات عملية مثل الاتفاقات النقدية والتأمينات على الصادرات، فليس للدبلوماسية الإقليمية قدرة على تغيير المشهد الاقتصادي.
بعبارة أخرى، المشكلة بنيوية لا شكلية، والجهود الهامشية لا تغيّر في المعادلات المركزية.
5ــ تبديل الأولويات بدلاً من إصلاح السياسة
من منظور تحليلي، يصيب الكاتب في اعتبار أنّ السياسة الخارجية ينبغي أن تركّز على القضايا الكبرى، مثل: إدارة التوترات الإقليمية، وتحسين العلاقات مع القوى الكبرى وفتح قنوات مع الغرب.
كما أن التوسّع في برامج ثانوية من دون معالجة هذه المعضلات الأساسية هو ــ عملياً ــ هروب من أصل المشكلة.
وعلى ما سبق، فالتعليق يقدّم تحليلاً إستراتيجياً متماسكاً ومبنياً على فهم عميق لبنية السياسة الخارجية الإيرانية.
يُحسب للكاتب أنّه لا يكتفي بانتقاد الظاهر، بل يتعامل مع جذور المشكلات، مثل: غياب الرؤية، وغياب الانسجام المؤسسي وانفصال الاقتصاد الإيراني عن النظام المالي الدولي. ومع أنّ المقال يحمل نبرة نقدية حادّة، إلا أنّه يستند إلى منطق واقعي يجعل منه قراءة قيّمة في سياق السياسات العامة.
ــــــــــــــــ
النص الأصلي مترجم من مقالة بعنوان “دیپلماسی مورد نیاز ایران” (بالعربية: الدبلوماسية التي تحتاجها إيران) للكاتب الإصلاحي نصرت الله تاجیک منشورة في صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية بتاريخ 25 آبان 1404 هـ. ش. الموافق 16 نوفمبر 2025.